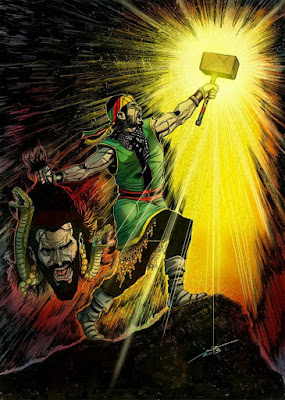أسلاف الكورد السومريين
د. مهدي كاكه يي
جميع المؤرخين وعلماء الآثار والباحثين يتفقون على أن السومريين كانوا من الأقوام غير السامية. يذكر العلامة طه باقر في مقدمة كتاب “من ألواح سومر” للمؤرخ صمويل كريمر (Samuel Noah Kramer) الذي قام بترجمته الى اللغة العربية في صفحة 8 ما يلي: وجلّ ما يمكن قوله بهذا الصدد أن مَن نُسمّيهم بالسومريين في تاريخ وادي الرافدَين، كانوا قوماً ليسوا من الأقوام السامية (الأقوام السامية هي تلك الأقوام التي تكلمتْ بإحدى اللغات السامية كالأكدية والبابلية في العراق والأمورية والكنعانية والآرامية والعبرانية في ربوع الشام والجزيرة العربية)، بل أن لغتهم هي من اللغات غير السامية.
فيستطرد المؤرخ طه باقر في حديثه بأن الباحث الإيرلندي “هنكس” يقول بأن الخط المسماري أوجده قوم غير ساميين، بل أن هذا القوم سبق البابليين الساميين في إستيطان وادي الرافدَين. نشر الباحث الإنكليزي الشهير “هنري رولنسون” بحثاً في عام 1855 في مجلة “الجمعية الآسيوية الملكية” يذكر فيه بأنه إكتشف كتابةً جديدةً بلُغةٍ غير سامية وجدها مدوّنة في الآجر وفي ألواح الطين في بعض المواقع القديمة في بلاد ما بين النهرَين، مثل “نفر” و”لارسا” و”الوركاء”. في عام 1856، ذكر الباحث الإيرلندي “هنكس” بأن هذه اللغة الجديدة هي من نوع اللغات الإلتصاقية وفي عام 1869 أطلق الباحث الفرنسي “أوبرت Oppert” على هذه اللغة الجديدة “اللغة السومرية” لأول مرة.
بدأ العصر الذي سبق العهد السومري على هيئة حضارة قروية زراعية أدخلها “الإيرانيون” من الشرق (أسلاف الكورد الزاگروسيين) الى جنوب العراق (صمويل كريمر: من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، مكتبة المثنى، بغداد ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، 1970، صفحة 356). هذا القول يؤكده المؤرخ البروفيسور “سبايزر Speisere” في صفحة 99 من كتابه المعنون “شعوب ما بين النهرين”، حيث يقول بأن العناصر الگوتية (أسلاف الكورد) كانت موجودة في جنوب العراق قبل تأسيس سومر وأسسوا بلاد سومر فيما بعد وشكلوا الحكومات فيها.
يذكر كل من الأستاذ طه باقر والدكتور عامر سليمان بأنه عند هجرة الأكديين الى شمال وادي الرافدين (جنوب كوردستان الحالية) في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كان السومريون و السوباريون يعيشون هناك وكانت المنطقة تُسمى ب”سوبارتو”. يضيف المؤرخان المذكوران بأنه جاء ذكر السوباريين في النصوص المسمارية منذ عصر فجر السلالات (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، 1973، صفحة 120، 476؛ عامر سليمان: العراق في التاريخ القديم، الموصل، دارالحكمة للطباعة والنشر، 1992، صفحة 119). من هنا نرى أن الموطن الأصلي للسومريين هو كوردستان وأنهم من أقوام جبال زاگروس التي هي الموطن الأصلي للكورد وأن السومريين هاجروا من كوردستان الى جنوب بلاد ما بين النهرَين وبنوا حضارة راقية هناك.
يذكر كل من الدكتور عبدالعزيز صالح في صفحة 448 من كتابه (الشرق الأدنى القديم –مصر والعراق، الجزء الأول، القاهرة، 1976م) والدكتور محمد بيومي مهران في كتابه المعنون (تاريخ العراق القديم، الاسكندرية، 1990، صفحة 90) والدكتور إبراهيم الفني في صفحة 319 من كتابه المعنون (التوراة) المنشور من قِبل (دار اليازوري للنشر والتوزيع) في العاصمة الأردنية، عمّان في عام 2009، بأن الموطن الأصلي للسومريين هو جبال زاگروس الكوردستانية.
في بعض مدن شمال بلاد ما بين النهرَين مثل مدينة آشور ونينوى، تم إكتشاف آثار للحضارة السومرية التي تعود لعصر فجر السلالات ولا سيما الفترة الأخيرة منه (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، عام 1973، صفحة 177). إكتشاف آثار سومرية في شمال بلاد ما بين النهرَين (كوردستان) يؤكد على أن كوردستان هي الموطن الأصلي للسومريين وأن السوباريين والسومريين عاشوا معاً هناك. هذا دليل مادي على كون كوردستان الموطن الأصلي للسومريين ولا مكان فيه لأية إجتهادات أو تحليلات.
يذكر عالم الآثار الدكتور بهنام أبو الصوف في إطروحته التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة كامبرج البريطانية في عام 1966، بأن السومريين لم يأتوا من خارج بلاد ما بين النهرَين، بل كانوا في منطقة سوبارتو وأن هذا الشعب في زمنٍ ما إنتقل الى الجنوب ونقل معه حضارته. ما يدعم كلام عالم الآثار بهنام أبو الصوف هو أن إنشاء حضارة زراعية متطورة وإختراع الكتابة من قِبل السومريين، يدلّان على أنهم كانوا يمتلكون أسس حضارية متقدمة قبل إنتقالهم الى جنوب بلاد ما بين النهرَين. هذا يدل على أن السومريين كانوا جزءً من أسلاف الكورد الزاگروسيين الذين إنتقلوا من كوردستان الى جنوب العراق الحالي، حيث أنّ أسلاف الكورد الزاگروسيين هم أول مَن قاموا ببناء الحضارة البشرية في المنطقة وأن باكورة الحضارة ظهرت على أرض كوردستان.
الآثار القديمة التي تم إكتشافها في كوردستان تثبت بأن كوردستان هي مهد الحضارة البشرية الأولى، حيث يذكر العالم الأمريكي البروفيسور (روبرت جون بريدوود) بأنه تمّ الإنتقال من حياة الصيد الى حياة الزراعة في كوردستان في حوالي عام 6000 – 10000 قبل الميلاد. كما أنه يضيف بأن الشعب الكوردي كان من أوائل الشعوب التي طوّرت الزراعة والصناعة ومن أوائل الشعوب التي تركت الكهوف لتعيش في منازل بها أدوات منزلية متطورة للإستعمال اليومي وأن الزراعة وتطوير المحاصيل قد وجدتا في كوردستان منذ (12) ألف سنة والتي إنتشرت منها إلى جنوب بلاد ما بين النهرَين، ثم إلى غرب الأناضول، ثم إلى الهضبة الإيرانية، ووصلت منذ ثمانية آلاف سنة إلى شمال أفريقيا ثم أوروبا و الهند. يضيف هذا العالم الأمريكي بأن الكثير من المحاصيل التي نعرفها الآن، كالقمح والذرة والشعير، قد إنطلقت من كوردستان. حول الصناعة، يؤكد البروفيسور (روبرت جون بريدوود) بأن الموقع الآثاري “چيانو” الواقع في شمال كوردستان يمكن أن يُطلق عليه إسم أقدم مدينة صناعية في العالم، حيث يُستخرج منه النحاس إلى يومنا هذا، كما عُثر فيه على صلصال دُوّن عليه التبادل التجاري. هذا يُشير الى أن السومريين المتحضرين كانوا من أحفاد الزاگروسيين الذين إبتكروا الزراعة والصناعة، حيث تعلموا الحضارة وأخذوا الخبرات من أسلافهم الزاگروسيين.بدأ العصر الذي سبق العهد السومري على هيئة حضارة قروية زراعية أدخلها “الإيرانيون” من الشرق (أسلاف الكورد الزاگروسيين) الى جنوب العراق (صمويل كريمر: من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، مكتبة المثنى، بغداد ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، 1970، صفحة 356). هذا القول يؤكده المؤرخ البروفيسور “سبايزر Speisere” في صفحة 99 من كتابه المعنون “شعوب ما بين النهرين”، حيث يقول بأن العناصر الگوتية (أسلاف الكورد) كانت موجودة في جنوب العراق قبل تأسيس سومر وأسسوا بلاد سومر فيما بعد وشكلوا الحكومات فيها.
يذكر كل من الأستاذ طه باقر والدكتور عامر سليمان بأنه عند هجرة الأكديين الى شمال وادي الرافدين (جنوب كوردستان الحالية) في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كان السومريون و السوباريون يعيشون هناك وكانت المنطقة تُسمى ب”سوبارتو”. يضيف المؤرخان المذكوران بأنه جاء ذكر السوباريين في النصوص المسمارية منذ عصر فجر السلالات (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، 1973، صفحة 120، 476؛ عامر سليمان: العراق في التاريخ القديم، الموصل، دارالحكمة للطباعة والنشر، 1992، صفحة 119). من هنا نرى أن الموطن الأصلي للسومريين هو كوردستان وأنهم من أقوام جبال زاگروس التي هي الموطن الأصلي للكورد وأن السومريين هاجروا من كوردستان الى جنوب بلاد ما بين النهرَين وبنوا حضارة راقية هناك.
يذكر كل من الدكتور عبدالعزيز صالح في صفحة 448 من كتابه (الشرق الأدنى القديم –مصر والعراق، الجزء الأول، القاهرة، 1976م) والدكتور محمد بيومي مهران في كتابه المعنون (تاريخ العراق القديم، الاسكندرية، 1990، صفحة 90) والدكتور إبراهيم الفني في صفحة 319 من كتابه المعنون (التوراة) المنشور من قِبل (دار اليازوري للنشر والتوزيع) في العاصمة الأردنية، عمّان في عام 2009، بأن الموطن الأصلي للسومريين هو جبال زاگروس الكوردستانية.
في بعض مدن شمال بلاد ما بين النهرَين مثل مدينة آشور ونينوى، تم إكتشاف آثار للحضارة السومرية التي تعود لعصر فجر السلالات ولا سيما الفترة الأخيرة منه (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، عام 1973، صفحة 177). إكتشاف آثار سومرية في شمال بلاد ما بين النهرَين (كوردستان) يؤكد على أن كوردستان هي الموطن الأصلي للسومريين وأن السوباريين والسومريين عاشوا معاً هناك. هذا دليل مادي على كون كوردستان الموطن الأصلي للسومريين ولا مكان فيه لأية إجتهادات أو تحليلات.
يذكر عالم الآثار الدكتور بهنام أبو الصوف في إطروحته التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة كامبرج البريطانية في عام 1966، بأن السومريين لم يأتوا من خارج بلاد ما بين النهرَين، بل كانوا في منطقة سوبارتو وأن هذا الشعب في زمنٍ ما إنتقل الى الجنوب ونقل معه حضارته. ما يدعم كلام عالم الآثار بهنام أبو الصوف هو أن إنشاء حضارة زراعية متطورة وإختراع الكتابة من قِبل السومريين، يدلّان على أنهم كانوا يمتلكون أسس حضارية متقدمة قبل إنتقالهم الى جنوب بلاد ما بين النهرَين. هذا يدل على أن السومريين كانوا جزءً من أسلاف الكورد الزاگروسيين الذين إنتقلوا من كوردستان الى جنوب العراق الحالي، حيث أنّ أسلاف الكورد الزاگروسيين هم أول مَن قاموا ببناء الحضارة البشرية في المنطقة وأن باكورة الحضارة ظهرت على أرض كوردستان.
يكشف بعض الأدبيات السومرية عن أصل السومريين. على سبيل المثال، إحدى أساطير الخلق السومرية المعنونة “قصيدة المعول” التي تعود جذورها إلى بدايات إبتكار الزراعة في كوردستان، حيث تقول القصيدة المذكورة بأن الإِله (انليل) بعد أن (أسرع بفصل السماء عن الأرض، عمل على خلق الإنسان الأول، فحفرَ شقاً في الأرض… ووضع بدايات البشرية في الشق، وعندما بدأ البشر بالظهور كالحشيش، كان انليل ينظر مرتاحاً إلى شعبه السومري). في الفقرة الأخيرة من هذه القصيدة، يكشف السومريون بوضوح عن أصلهم الزاگروسي، وأنهم أحفاد أُولئك الأسلاف الذين إبتكروا الزراعة في كوردستان وبنوا أقدم القرى الزراعية في العالم.
الكتابات السومرية تُخبرنا بأن موطن الآلهة (دلمون) هو المكان الذي يمنح السعادة الأبدية للإنسان بعد موته، ولهذا السبب كان السومريون يدفنون أفراد العائلة المالكة في هذه المنطقة عند وفاتهم تكريماً لهم للخدمات الجليلة التي يقدمونها للآلهة خلال حياتهم، حيث أن (دلمون) كانت فردوس السومريين.
يذكر الدكتور مؤيد عبدالستار في مقاله القّيم المعنون ( دلمون أرض السعادة السومرية … من جبال زاگروس الى البحرين) بأن الباحث (ديفد رول)، في هامش رقم 1 في صفحة 241 من دراسته المعنونة (Legend) (مصدر رقم 2) يشير الى دراسة الباحث الكبير صموئيل نوح كريمر المنشورة في مجلة المدارس الأمريكية للبحوث الشرقية عدد ديسمبر/كانون الأول عام 1944 والمعنونة “دلمون أرض الأحياء”، حيث أن كريمر يستنتج من خلال نتائج بحثه المذكور بأن منطقة (دلمون) تقع جنوب غرب ايران (جبال زاگروس) (مصدر رقم 3). يستطرد الدكتور مؤيد عبدالستار في مقاله المذكور بأنه يتم ذكر (دلمون) بإسمها (جبل دلمون Akk Kur – Dilmun) وهذا يدل على أن (دلمون) هي منطقة جبلية. كما هو معروف، فأن كوردستان هي المنطقة الجبلية الوحيدة في بلاد ما بين النهرَين. الملاحم السومرية تذكر أيضاً بأن منطقة (دلمون) تقع عند مشرق الشمس، وهذا يشير الى أن موطن الآلهة السومرية (دلمون) موجود في جبال زاگروس المُشرفة على سهول بلاد ما بين النهرَين. يضيف الدكتور مؤيد بأنه في شرق كوردستان، توجد قرية صغيرة تقع بين بحيرة أورمية ونهر ميدان تُدعى (دلمان Dilman) و التي قد تكون لها علاقة بمنطقة (دلمون) السومرية.
هناك الكثير من الكلمات السومرية التي لا تزال حيّة في اللغة الكوردية وتشكّل قسماً كبيراً من مفردات اللغة الكوردية، رغم الفاصل الزمني الكبير الذي يبلغ آلاف السنين الذي يفصل بين اللغتين والتغييرات التي مرت على اللغة الكوردية خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة.
“ملحمة كلگامیش” ترتبط تسميتها بوضوح ببطل الملحمة الذي يتشبه بالجاموس ويتكرر إسم الجاموس لمرّات عديدة في الملحمة، حيث أنّ “كلگامیش” قام بصرع وقتل الجاموس (گامیش) السماوي وأنه من المرجح أن يكون إكتسابه لإسمه هذا متأتياً لهذا السبب بإضافة “كَل” الى “گامیش” ليصبح “كلگامیش”. هكذا نرى بأنّ إسم الملحمة نفسها هو إسم كوردي خالص، يتألف من ثلاث كلمات هي “كَل” التي تعني “فحل” وكلمة “كَا” التي تعني “ثور” وكلمة “ميش” التي تعني “حيوان”. وبدمج كلمة “كَا” و”ميش” تنتج لنا الكلمة المركبة “گاميش” التي تعني في اللغة الكوردية “الجاموس” وبذلك يعني إسم الملحمة “فحل الجاموس”. بينما يُسمّي الكورد “البقرة” ب”مانگا” أي “أنثى الثور”. إنّ إختيار السومريين للجاموس ليكون رمزاً لهم، يعكس بوضوح تأثرهم ببيئة الأهوار التي كانوا يعيشون فيها، حيث إشتهرت بلاد سومر بكثرة الجاموس فيها والتي لا تزال الى يومنا تشتهر المنطقة بتربية هذا الحيوان. العرب إقتبسوا مفردة “جاموس” من المفردة السومرية “گامیش” وقاموا بتحويرها لتتلاءم مع النطق العربي.
من جهة أخرى، لو ننظر الى أبطال ملحمة “كلگامیش”، نرى أن الآشخاص البارزين في الملحمة يحملون أسماء كوردية. “أورشنابي”، الذي يساعد “كلگامیش” في بحثه عن سرّ الخلود، إسمه يعني ال(ملاّح). الى الوقت الحاضر يستعمل الكورد مفردة “شناو” التي تعني “السباحة”. “أوتناوپشتم” هو إسم جد “كلگامیش” والذي عنده سر الخلود. هذا الإسم يعني “الذين أتوا من بعدي” ومضمون معناه هو “الخلود”. في اللغة الكوردية يُقال “هاتنوپشتم” الذي يعني أيضاً “الذين أتوا من بعدي” والعبارة هذه، كما نرى، هي نفسها في اللغة السومرية و الكوردية.
إن تركيبة اللغة السومرية والكوردية متشابهة، حيث أن كلاهما لغتان إلتصاقيتان، يتم فيهما تركيب كلمات مركبة من كلمتَين أو أكثر من الكلمات البسيطة. من جانبٍ آخر فأن اللغة الكوردية لا تزال تحتفظ بكثير من الكلمات السومرية رغم مرور آلاف السنين على إنقراض اللغة السومرية، لدرجةٍ أن إسم بلاد سومر لا يزال باقياً في اللغة الكوردية ويُعطي نفس المعنى، حيث أن إسم بلاد سومر باللغة السومرية الذي تتم كتابته بالخط المسماري، هو (كي إن جي Ki -en –gi)، الذي يعني “البلاد السيدة” (عامر سليمان، وأحمد مالك الفِتْيان: محاضرات في التاريخ القديم، 1978، صفحة 25). هذا الإسم في اللغة الكوردية يعني “مكان أو بلاد سادة الأرض”.
قام السومريون ببناء معابدهم على أماكن مرتفعة شبيهة بالجبل (زَقُورة) ورسموا الأشجار والحيوانات الجبلية كالوعل والماعز على الأختام الأسطوانية التي كانوا يصنعونها (سامي سعيد الأحمد: السومريون وتراثهم الحضاري. مطبعة الجامعة، بغداد، 1975، صفحة 42، 82؛ فاضل عبد الواحد علي: من سومر إلى التوراة. سينا للنشر، القاهرة، 1996، صفحة 22). كل هذا يدلّ على الأصل الجبلي للسومريين، حيث كانت جبال زاگروس الموطن الأصلي لهم. كما أن هناك مشتركات كثيرة في العقائد بين السومريين و الكورد.
كما أن تأسيس السومريين لممالك المدن يرتبط بِخلفتيهم الجبلية، حيث أن الطبيعة الجبلية تعزل السكان عن بعضها بسبب الحواجز الجبلية الطبيعية التي تجعل سكان كل منطقة معزولين عن البعض و يُشكّلون مجتمعاً شبه مستقل، يدير أمور حياته بِنفسه. هكذا فأن هذه الثقافة الجبلية إنتقلت مع السومريين عندما هاجروا من كوردستان الى جنوب بلاد ما بين النهرَين وإحتفظ سكان كل منطقة في كوردستان بإستقلاليتهم بعد الإنتقال الى جنوب بلاد ما بين النهرين و أسست كل مجموعة سكانية، التي كانت تعيش معاً في كوردستان ضمن جغرافية متصلة، مملكة مستقلة لنفسها في موطنها الجديد. من الجدير بالذكر أن عزل الطبيعة الجبلية لسكان كوردستان عن بعضها هو أحد أهم الأسباب التي أدت الى عدم إتحاد الشعب الكوردي وفقدانه لقيادة سياسية موحدة وبالتالي تأسيس كيان سياسي مستقل لنفسه. كما أنه أيضاً أحد الأسباب الرئيسية في رسم شخصية كوردية تعشق الحرية والإستقلالية و ترفض أن تأتمر من قِبل قيادات حزبية و سياسية.
يعتقد بعض المؤرخين بأن السوباريين والسومريين ينتمون الى أصل واحد وأنهم مرتبطون مع البعض بصلة القرابة أو على الأقل أنهما كانا يعيشان معاً في شمال بلاد ما بين النهرَين قبل إنتقال السومريين الى جنوب بلاد ما بين النَهرَين وإستقرارهم هناك (الدكتور نعيم فرح: معالم حضارات العالم القديم، دارالفكر، 1973، صفحة 198). يذكر الدكتور نعيم فرح في كتابه المذكور أيضاً بأن السوباريين والسومريين ينحدرون من الگوتيين (أسلاف الكورد) الذين كان موطنهم سلسلة جبال زاگروس. إن أسماء كثير من المدن السومرية هي ليست أسماء سومرية، بل سوبارية، أمثال مدن: أور، أريدو، أوروك، سِپار، لارْسا، لَگَش، وكذلك قد تكون المفردات المشتركة بين اللغتين السوبارية والسومرية هي مفردات سوبارية، مثل كلمة “باتيس – باتيز” التي تعني “الملِك” (الدكتور سامي سعيد الأحمد: السومريون وتراثهم الحضاري، منشورات الجمعية التاريخية العراقية، بغداد، 1975). هذا يدعم الرأي القائل بوجود صلة القرابة بين السوباريين والسومريين.
مرّ عصر الممالك السومرية بثلاث أدوار. دور فجر السلالات الأول (2900/2800-2700 قبل الميلاد)، حيث أن هذا الدور يمثل المرحلة الأخيرة من أطوار العصر الشبيه بالكتابي و ضمَّ طور الوركاء وجمدة نصر. دور فجر السلالات الثاني (2700-2550 قبل الميلاد)، في هذا الدور تكاملت الكتابة المسمارية وتم إستخدامها وظهر التدوين الرسمي وتم أيضاً تأسيس ممالك مستقلة في المدن. دور فجر السلالات الثالث (2550- 2334)، في هذا الدور وصلت الحضارة السومرية في أور الى أعلى مراحل إزدهارها ونضجها. سلالة الوركاء الأولى هي من السلالات الشهيرة في دور فجر السلالات الثالث، حيث إشتهرت بملكها الخامس “كلكامش” (حوالي 2700 قبل الميلاد) الذي هو بطل ملحمة كلكامش الشهيرة. كما ظهر في هذا الدور كلّ من سلالة (لكش) و(أوما) اللتين كانتا في صراع مرير، إستمر لحوالي مائة عام (فاضل عبدالواحد علي. العراق في التاريخ – السومريون والاكديون – بغداد، 1983، صفحة 66 – 67؛ مصدر رقم 4).
يقول الأستاذ طه باقر في مقدمته لكتاب صمويل كريمر والذي ترجمه الى العربية، بأن السومريين على ماهو مجمع عليه، المؤسسون الأوائل لمقومات الحضارة والعمران ومنهم إقتبس الساميون في بلاد ما بين النهرين أصول حضارتهم ولا يقتصر تراثهم الثقافي بكونه أساس حضارة وادي الرافدَين، بل أنهم أثرّوا في جميع شعوب الشرق الأدنى ويتجلى ذلك في مجالات عديدة، حيث أن السومريين كانوا أول مَن أوجد وطوّر الكتابة التي عُرفت بعدئذٍ بالخط المسماري وهو الخط الذي إقتبسه معظم شعوب الشرق الأدنى القديم (صمويل كريمر: من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، مكتبة المثنى، بغداد ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، 1970، صفحة 9-13).
تميّز السومريون بالإبداع في الحضارة المادية كأسس العمارة والفنون والنظم الإجتماعية والسياسية والى غير ذلك من مقومات الحضارة التي أثرّت بشكل كبير في تقدم شعوب الشرق الأدنى. كما أن السومريين أوجدوا آراءً و تصورات و أفكاراً في الديانة وفي المجالات الروحية والعقلية الأخرى، وأن الكثير منها دخلَ الى معتقدات الديانة اليهودية والمسيحية وإنتقل الكثير منها الى الحضارة الحديثة. أنتج السومريون نتاجاً أدبياَ أصيلاً الذي كان معظمه شعراً وكان تأثيره عميقاً في الأقوام القديمة وإستمر تأثيره الى الحضارة الحاضرة.
إبتكر السومريون الكتابة في جنوب بلاد ما بين النهرَين في حوالي عام 3000 قبل الميلاد وبذلك بدأ عصر التدوين الذي من خلاله إستطاع الباحثون الإطلاع على الحضارة السومرية والحضارات التي تلت هذه الحضارة.
أهم الأعمال التي قام بها السومريون هي إختراعهم للكتابة والأرقام وإبتكارهم للمدن. السومريون هم أول مَن إخترعوا الكتابة والأرقام والتي أخذتها الأقوام الأخرى منهم، حيث أننا لو تصفحنا الكتب الغربية التي تدرس تأريخ تطور اللغات والأرقام في العالم، لنرى أنها تذكر ذلك وتؤكد عليه. السومريون بنوا حضارة متقدمة، حيث طوروا الزراعة والري وإخترعوا المحراث والدولاب والعربة ومخرطة الخزف والقارب الشراعي والبرمشمة واللحام والدهان وصياغة الذهب والترصيع بالأحجار الكريمة وعمارة القرميد العادي والمشوي وإنشاء الصروح وإستعمال الذهب والفضة في تقويم السلع وإبتكروا العقود التجارية ونظام الإئتمان ووضعوا كتب القوانين، وهم أول من إبتكروا الطابوق كوحدة معمارية مصنعة بدل الحجر.
يُحدّثنا التأريخ أيضاً بأن السومريين تمسكوا بالحق والعدالة والحرية الشخصية وكرهوا الظلم والعنف، حيث وضعوا القوانين لتنظيم حياتهم على ضوء هذه المبادئ الإنسانية.
برع السومريون في علوم الموسيقى، حيث أن التنقيبات الأثرية في مدفن زوجة ملك أور، الملكة شبعاد، التي قام بها علماء الآثار البريطانيون في عام 1918، قادت الى العثور على مجموعة من العازفين مع 11 قيثارة، إضافة لقيثارة كبيرة مكونة من 30 وتراً وهي القيثارة السومرية. الحضارات اللاحقة قد أخذت معظم العلوم ومنها الموسيقى من الزقورات (أماكن العبادة)، (زقورة أور وزقورة دوركاريكالزو) الواقعة غرب بغداد وكانت زقورات وادي الرافدين قُبلة لأنظار الناس ومنها إستلهم المصريون أهراماتهم وهياكلهم الأولى (ب. ليرخ: دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين. ترجمة الدكتور عبدي حاجي، 1992).
تشتهر مقبرة أور الملكية بآثارها النفيسة، حيث يعود معظم هذه القبور إلى عصر فجر السلالات الثالث. تم إكتشاف أكثر من 2500 مقبرة، وأن 16 مقبرة على الأقل من هذه المقابر هي مقابر جماعية، دُفنت فيها أفراد العائلات السومرية المالكة، حيث كان يتم دفنهم في مقابر جماعية مع حاشيتهم وأتباعهم ومتاعهم وأثاثهم (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، عام 1973، صفحة 277 – 283، فاضل عبد الواحد علي، من الواح سومر الى التوراة. بغداد، 1989، صفحة 74- 77).
كما تم إكتشاف مقابر جماعية تعود لأسلاف الكورد، الكيشيين و في مدينة “نوزي” (مدينة كركوك الحالية) تم أيضاً إكتشاف مقابر جماعية تعود للخوريين وكذلك في مدينة ماري التي تبعد حوالي 11 كيلومتراً عن بلدة البوكمال الواقعة في سوريا الحالية (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الطبعة الأولى، بغداد، عام 1973، صفحة 283 – 285).
أنشأ السومريون ممالك (ممالك المدن)، حيث كان كل مملكة تتألف من مدينة واحدة، مؤلفة من مركز المدينة وضواحيها من حقول وبساتين تابعة لها (جورج رو: العراق القديم. ترجمة وتعليق حسين علوان حسين، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، الطبعة الثانية، 1986م، صفحة 181 – 182). كانت الممالك السومرية مستقلة عن بعضها ولكل مملكة (مدينة) حاكمها وإلهه الخاص بها وتعاقبت على حكمها سلالات كثيرة وكانت تتميز العلاقات بين الممالك السومرية بالعداء والنزاعات والحروب (عامر سليمان: العراق في التاريخ القديم، الموصل، دارالحكمة للطباعة والنشر، 1992، صفحة 139).
قام السومريون ببناء العديد من المدن التي كان كل مدينة منها عبارة عن مملكة سومرية مستقلة. من المدن السومرية هي (أوروك) التي تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتبعد بحوالي 30 كيلومتر عن شرق مدينة السماوة، ومدينة (لگش) التي تقع في جنوب مدينة قلعة سكر العراقية، و(أور) و(اريدو) الواقعتان في جنوب غرب مدينة الناصرية في جنوب العراق و( لارسا) التي تقع شمال غرب مدينة الناصرية العراقية و(أوما) الواقعة في جنوب غرب مدينة قلعة سكر في العراق ومدينة (شروباك) التي تقع في شمال مدينة (أوروك)، حيث أنه خلال التنقيبات التي أُجريت هناك في عام 1902 ــ 1903، تم إكتشاف عدد كبير من الألواح المدرسية التي تعود للعصر السومري والتي كان يتم فيها تدريس تلاميذ المدارس، ومدينة (إيسن) التي تقع في جنوب شرق مدينة الديوانية العراقية، ومدينة (ادب) التي تقع في شمال غرب مدينة (أوما)، ومدينة (نيبور) الواقعة في شرق مدينة الديوانية، ومدينة (اكشاك) التي يقع موقعها في المدائن التي تقع جنوب شرق العاصمة بغداد، ومدينة (كيش) التي تقع آثارها في محافظة بابل و كانت إحدى المدن الرئيسية للسومريين، حيث أن الأساطير السومرية تُخبرنا بأنها أول مدينة يحكمها ملِك بعد الطوفان الكبير الذي تم ذكره في الأساطير السومرية وفي الديانة اليهودية و المسيحية والإسلامية، ومدينة (سيبار) التي تقع على الضفة الشرقية من الفرات، حوالي 60 كيلومتر شمال بابل، ومدينة (شوروباك) التي تقع على نهر الفرات، حوالي 225 كيلومتر جنوب شرق مدينة الناصرية، في هذه المدينة السومرية تم إكتشاف أول تقويم زراعي، يضم عدداً من الوصايا والتعليمات الزراعية الخاصة بتهيئة الحقل وبموسم البذار والري والحصاد وضعها فلاح سومري لإبنه على رُقيم من طين يحوي 35 فقرة (ليو اوينهايم: بلاد ما بين النهرَين. ترجمة وتحقيق سعدي فيضي عبدالرزاق، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1981، صفحة 463 – 512؛ نيكولاس بوستگيت: حضارة العراق وآثاره – تاريخ مصور، ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر، 1991، صفحة 125- 142).
المصادر
1. Speisere, Ephraim A. (1930). Mesopotamian Origins. The basic population of the Near East. Philadelphia, USA.
2. Rohl, David M. LEGEND Volume: 2, London, 1999, pp.237.
3. Kramer, Samuel Noah (1944). Dilmun, the Land of the Living. Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
4. Hallo, William W. (1957). Early Mesopotamian Royal Titles. New Haven, CT: American Oriental Society, pp 35 -50
1. Speisere, Ephraim A. (1930). Mesopotamian Origins. The basic population of the Near East. Philadelphia, USA.
2. Rohl, David M. LEGEND Volume: 2, London, 1999, pp.237.
3. Kramer, Samuel Noah (1944). Dilmun, the Land of the Living. Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
4. Hallo, William W. (1957). Early Mesopotamian Royal Titles. New Haven, CT: American Oriental Society, pp 35 -50